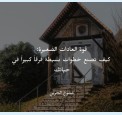بقلم - د. أحمد بن سعد بن غرم الغامدي
إن الإنسان لم يخلق نفسه، ولا يمكن أن يكون المخلوق خالقاً، لأن الخالق لا يكون مخلوقاً، ولا المربوب ربّاً، وقد قرر القرآن هذا الأصل بأوجز عبارة وأعظم حجة في قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}. فلو تأمل العاقل هذه الآية حق التأمل لعلم يقيناً أن وجوده من غير خالقٍ محال، وأنه عاجز عن خلق نفسه أو خلق غيره، لأنه لا يملك الحياة ولا الموت ولا النشور.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أنه يستقل بنفسه دون ربه فقد جهل ربه وجهل نفسه، فإن العبد فقير إلى الله في كل حال، بل فقره إليه ذاتي لا ينفك عنه طرفة عين.
فالإنسان محكوم بقدر الله في وجوده، لا استقلال له في إيجاد ذاته، ولا حول له إلا بإرادة الله ومشيئته، وهو عبدٌ مملوك، لا ربٌّ متصرف، وما عليه إلا أن يعرف هذا الموقع ليقوم بوظيفته في العبودية، فإن من جهل أنه عبد تطاول إلى مقام الربوبية، فضاع بين الزهو والغرور.
ثم إن الإنسان محدود بزمانٍ يقصر عن إدراك الخلود، ومكانٍ لا يستطيع تجاوزه، فزمانه يبدأ بولادته وينتهي بموته، ومكانه الأرض التي خُلق منها وإليها يعود، كما قال تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}. فهذه حدود وجوده الدنيوي، لا يستطيع أن يخرج عنها، ولا أن يحيا خارج سلطانها، ولذلك كان من العدل أن يحدد الإنسان موقعه من الزمن الذي يعيش فيه، فيعرف أنه مرحلة امتحان قصيرة لا دار إقامة، وأن المكان الذي يعيش فيه أمانة استخلفه الله فيه ليبتليه كما قال سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}.
ومن طبيعة الإنسان أنه مريدٌ حساس، يشعر ويريد ويسعى، ولكن إرادته هذه لا تخرج عن سلطان الله، بل هي داخلة تحت إرادته سبحانه، كما قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}. فالإرادة الإنسانية محدودة بالعلم والقدرة، بينما إرادة الله مطلقة شاملة.
ولهذا جعل الله للعبد قدرةً واختياراً يُثاب ويعاقب عليه، وجعل مشيئته تابعة لمشيئته تعالى تحقيقاً للعدل ورفعاً للظلم، فلو كان العبد مجبراً لما صح التكليف، ولو كان مستقلاً لما صح التوحيد، وكلا القولين باطل، والحق أن له إرادة تحت إرادة الله.
قال ابن القيم رحمه الله: العبد فاعلٌ حقيقة، والله خالق فعله، وهو مريد بإرادة الله، وقدرة العبد سببٌ من أسباب المقدور. وبهذا التوازن يثبت العدل الإلهي وتستقيم الحكمة الربانية.
وحيث إن الإنسان مريدٌ حساس، فلا بد له من علمٍ يهديه، وإلا ضلّ الطريق، إذ لا يكفي العقل وحده لمعرفة كل نافعٍ وضار، لأنه ناقصٌ بطبعه، يعتريه الجهل والهوى والمرض، ولذلك لم يترك الله عباده لعقولهم وحدها، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الوحي ميزاناً للعقل، والعقل شاهداً على صدق الوحي، كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.
فالوحي نورٌ للعقل، والعقل آلة لفهم الوحي، ومن فصل أحدهما عن الآخر فقد ضلّ.
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يصدّقه ويشهد له، فإن نور العقل هو انعكاس لنور الوحي ، وإذا اجتمعا ازداد النور نوراً.
فمن أراد أن يحدد موقعه من العلم، فليعلم أن العلم النافع هو الذي يوصله إلى العدل والإحسان، والضارّ هو الذي يوقعه في الظلم والطغيان.
فمن تعلم ليعمل ويهتدي ويدعو إلى الحق فقد علم موقعه، ومن تعلم ليجادل أو ليُعجب الناس بعلمه فقد خسر موقعه.
وحيث إن الله تعالى غني عن خلقه لا يستقوي بهم من ضعفٍ ولا يستكثر بهم من قلةٍ، فقد خلقهم رحمةً بهم وتفضلاً عليهم، وأكرمهم بأن عرّفهم بنفسه وبما يحبه ويرضاه، فبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ليقيم عليهم الحجة ويبين لهم الطريق المستقيم، فقال سبحانه: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}.
فالرسل والكتب هم البوصلة الإلهية التي تحدد موقع الإنسان من رضا الله وغضبه، فمن اتبعهم فقد اهتدى، ومن أعرض عنهم فقد ضل، لأن الله أمر بالعدل والإحسان فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، فمن جعل العدل منهجه والإحسان غايته فقد استقام على الصراط، ومن خالفهما فقد حاد عن الحق.
ولما كان الإنسان مخلوقاً ضعيفاً بين بدايته ونهايته، فقد بين الله مراحله بقوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً}.
ففي ضعفه الأول لا تكليف عليه، وفي قوته يُكلّف، وفي ضعفه الثاني يُخفف عنه ويرفع عنه التكليف، وكلها مراحل تدل على أن الإنسان لا يملك لنفسه حولاً ولا طولاً، وأن قوته مؤقتة وضعفه دائم، فلا ينبغي له أن يتكبر على خالقه، بل يسعى في كل طورٍ من حياته أن يكون موقعه من الله موقع عبوديةٍ وافتقار.
ولما كانت للإنسان إرادة واختيار، جعل الله الجزاء مرتباً على العمل، فقال: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. فالمحسنون لهم الحسنى وزيادة، والمسيئون لهم السوء والعذاب، وهذا عدل الله الذي لا يظلم فيه أحداً، فمن حدد موقعه في الإحسان استعد للحسنى، ومن حدد موقعه في الظلم استحق العقوبة.
والشاهد من ذلك كله أن يراجع المرء موقعه من ربه ومن شرعه ومن عمره ومن نفسه، أين هو من أمر الله؟ وأين هو من طاعة نبيه؟ وأين هو من غايته التي خُلق لها؟ قال تعالى: {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}، لكن العاقبة معلومة: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}. فحدد موقعك قبل أن يحدده عملك، ووازن حالك قبل أن يُوزن لك، فإن اليوم عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل.
قال ابن تيمية رحمه الله: من لم يعرف موقعه من الله لم يعرف موقع الله منه، ومن لم يعرف قدر نفسه لم يعرف قدر ربه، ومن لم يعرف طريقه ضل في المفازات.
فالله الله في معرفة موقعك من الحق، فإن الطريق بيّن، والميزان منصوب، والموعد قريب، والعدل واقع لا محالة، فحدد موقعك قبل أن يسبقك أجلك، واستقم على الصراط قبل أن يطوى العمل، فإن العاقل من عرف موقعه، فقام بحق خالقه، وعدل في شأن نفسه، وأحسن في معاشه، فذلك موقع العدل والإحسان الذي يصلح له ولا يصلح له غيره .